


بينما كنت أنتظر الميكانيكي وهو يصلح إطارات سيارتي قبل توجهي للعمل، سمعت صوت نقرات عالية على زجاج نافذة السيارة، فتحت النافذة لتباشرني امرأة قائلة: "هل عرفتِنى؟!"
استغرق الأمر مني وهلة قبل أن أقول: "نعم!"
كانت نعمة، عرفتها من صوتها المميز.
كان يمكنني القول: "لا"، وأغادر؛ لأن الحديث معها شُبهة في حيّنا، لكني كنت في ذلك الوقت قد تجاوزت المجتمع وأحكامه المسبقة، ولم أعد أهتم لرأي الناس وماذا سيقولون علينا، تمردت على عاداته وتقاليده منذ زمن طويل، فليذهب حيّنا وكلام الناس للجحيم!
لذا أشكر الصدف التي أخرت هذا اللقاء إلى هذه اللحظة التي تصادفت مع تحرري من قيود المجتمع وكلام الناس.
ألقيت عليها التحية وتحدثت معها قليلًا عن أيام الطفولة، كنا نضحك بصدق، لم أستطع نبذها مثل الجميع.
عادت ذكرياتي بسرعة إلى ما قبل أكثر من عشرين عامًا.
كانت لدينا جارة وهي أم لفتاتين جميلتين، كنت أراها عندما كنت طفلة في الرابعة من عمري، إنها ذات ملامح جميلة جدًا، كنت دائمة التحديق بها كعادة الأطفال البريئة، تحليلي الظاهري في ذلك العمر يخبرني أنني أرى امرأة جميلة جدًا ومتناسقة الملامح، فنانة في صنع حلوى (الهريس) المنزلي، لا أعلم لماذا لم أعد الآن أستسيغ (الهريس) بشكل عام -وليس الذي تصنعه جارتنا فقط- بينما كنت متيمة به في طفولتي، ربما الأمر عائد لأن الأطفال غالبًا يحبون أي شيء حلو بغض النظر عن طعمه وجودة صنعه ومدى توازن السكر فيه.
أما تحليلي الأعمق عن شخصية هذه المرأة الآن أنها امرأة عادية جدًا، عادية إلى حد مخيف! نسخة مكررة من النساء اللواتي نشأن في بيئة ذكورية ونظام أبوي كامل متكامل دون نقص، مع خليط من قلة الحيلة واليأس والعجز.
أما زوجها فهو تلك النسخة القديمة من الرجال متحملي المسؤولية دون كلل أو ملل أو توقف، يشكل نموذج الحب التقليدي الجميل لزوجته وأبنائه بطريقة أقل رومانسية وأكثر فعلًا.
هذه الجارة لديها ابنة أكبر مني تدعى "سعيدة"، وأخرى أصغر مني بعامين، وهي "نعمة" التي تجلس أمامي الآن في السيارة.
هذا في عز معرفتنا بهم عندما كانوا يقيمون قريبا جدًا من بيتنا، ثم لاحقًا لما قلّت الزيارات بيننا وكبرنا قليلًا، انتقلوا إلى منزل أبعد، حينها أنجبت جارتنا ولدًا واحدًا لا أعرف عنه الكثير، اسمه أحمد.
حينها قالوا الناس مهنئين جارنا الذي كانوا يسمونه "أبو أحمد" حتى قبل أن يولد "أحمد": "مبروك! الآن أصبح أحمد حقيقيًا."
عندما كانت سعيدة أكبر اطفالة كانوا يسمونه "أبو سعيدة"، لكن عندما كبرت قليلًا أصبح من العيب مناداته باسمها، لذا أصبحت الكنية: "أبو أحمد."
مرت السنوات وكبرنا، وليتنا لم نكبر..
أتذكر عندما كنت في الثانية عشرة من عمري، سافر زوج جارتنا أبو أحمد إلى إحدى دول الخليج وغاب فترة طويلة نسبيًا، خمس سنوات متتالية؛ بسبب رغبته في تأمين حياة كريمة لأسرته بعد أن ضاقت بهم سبل العيش.
في السنة الرابعة من غيابه تقدم لابنته الكبرى "سعيدة" شاب يبلغ من العمر عشرين عامًا، وكان عمرها هي حينها سبعة عشر عامًا.
وافقت جارتنا أم أحمد بسرعة وجعلت أخاها -خال سعيدة- ولي أمرها في توقيع عقد الزواج، وتم ذلك بعلم الأب رغم معارضته الطفيفة.
تركت سعيدة دراستها وتزوجت.
بعد فترة من الزواج، أصبح زوج سعيدة يُطلق لحيته، يجلس في غرفة مظلمة، ويعامل ابنة جارتنا سعيدة بطريقة سيئة ويشك في أخلاقها.
كانت أم أحمد تأتي إلينا وتشكي همها قائلة: "أنا خائفة أن أخبر زوجي بذلك فيلومني؛ لأنني أنا من أصرّيت على هذه الزيجة."
كانت أمي تنصحها قائلة: "لا بأس! يلومك فترة بسيطة ولا تلومي نفسك العمر كله لو حصل لابنتك شيء سيئ.".
لكن رد جارتنا دائمًا وأبدًا: "ستخرج سمعة سيئة عنا، أن بنتي مطلقة."
عندما كانت سعيدة تزور أمها، كانت تجلس صامتة وكأنها مصدومة من شيء ما.
في إحدى المرات جئت لزيارتهم وكانت موجودة، لكن نظراتها كانت غير مستقرة، وأصبحت نادرة الكلام بعد أن كانت ضحوكة، رأيت على يدها أثار كدمات، وفهمت أنها تعاني بصمت.
مرت سنة، وعاد زوج جارتنا أبو أحمد من الخليج. عندما عرف بالأمر، غضب وكاد يضرب الشاب. تدخل أهل الشاب وقالوا إنه يعاني من حالة نفسية وأن ابنته سعيدة حامل، وأنه لا داعي للطلاق، وتعهدوا بمعالجته نفسيًا.
مرت سنوات لم أعد أسمع فيها عن سعيدة كثيرًا؛ لأنها سافرت إلى إحدى دول الخليج مع زوجها كما تقول أمها. كنا كلما سألنا عنها أجابت أمها بشكل مقتضب: "هي بخير." فقط.
*******
تزوجت نعمة مبكرًا وتطلقت مبكرًا أيضًا!
عادت نعمة إلى منزل والديها بطفلة تنمو في أحشائها. طوال فترة الحمل، كانت تصارع مع والديها للحصول على الطلاق، لكنها لم تحصل عليه. بعد ولادتها لابنتها بيوم، جاءت جدة الطفلة (أم الزوج) وعرضت عرضًا غير مغرٍ: الحرية مقابل التنازل كليًا عن الطفلة.
وتحت ضغط مروع، قبلت نعمة بالصفقة.
وهذا ما حصل؛ حصلت نعمة على الطلاق وتنازلت عن طفلتها.
بعد أشهر، مرضت جارتنا أم أحمد بسرطان الغدة الدرقية، ياله من مشهد مأساوي! كيف أصبحت هزيلة شاحبة عاجزة عن الكلام بسبب العلاج الكيميائي. كان زوجها شديد الحزن، يحملها على ظهره بعد جلسات العلاج الكيميائي، يطبخ لها الطعام ويطعمها بيديه، كان دائم الحسرة، ينتظر بقلق بالغ أن يعود للمنزل ليجد زوجته قد فارقت الحياة. لم يكن هو الوحيد الذي ينتظر ذلك، بل الجميع. ومع ذلك، لم تمت. مات هو بحادث مروري مؤسف؛ سائق دراجة نارية صدمه بقوة جعلته يطير عدة أمتار ويصطدم بجدار إسمنتي ذي قضبان حديدية بارزة. مات على الفور.
وُصف لي أنه نزف بغزارة من فمه وأنفه، وأصبح بياض عينيه شديد الحمرة مع فتحة كبيرة خلف جمجمته.
أذكر أن كل رجال الحي خرجوا في جنازته، ممسكين بيد ابنه المنهار كليًا خوفًا من وقوعه. كان المشهد محزنًا للغاية. عندما دفنوا جارنا، أمسك رجال الحي يد ابنه أحمد وقالوا له: "أنت الآن رجل المنزل، والرجال لا يبكون. لا تدخل على أمك وأختك وأنت تبكي."
كان يغالب دمعه ويتعرض لضغط نفسي كبير حتى يظهر بمظهر الرجل الشديد!
أما سائق الدراجة النارية الذي قتل جارنا فقد كان من أسرة فقيرة جدًا، ظل مسجونًا لفترة طويلة لأنه لم يستطع دفع الدية.
كان الجميع يقولون: "سبحان الله! الأعمار بيد الله." توقع الجميع موت الجارة لكنها عاشت ومات زوجها وافر الصحة.
ازدادت صحة جارتنا سوءًا بعد وفاة زوجها، وزاد الضغط على نعمة لأنها الوحيدة التي تعتني بأمها، وكانت على وشك الانهيار.
******
دخلت نعمة في نوبة سعال شديد قطعت معها شريط ذكرياتي.
قلت لها: "كيف حال حياتك الآن؟"
أجابت بتنهيدة طويلة: "بخير."
قلت لها: "وفّى؟!"
أجابت: "وفّى."
******
قالت لي نعمة دون أن تنظر إلي: "بعد تجربة طلاقي المروعة وتنازلي قسرًا عن ابنتي، دخلت في دوامة لا نهائية من الحزن والحسرة. لم أستطع أن أمارس أمومتي أبدًا.زاد عليّ الضغط بسبب مرض أمي وموت والدي المروع. كان بصيص الأمل الوحيد المتبقي هو أخي الأصغر أحمد.
أذكر بالضبط متى تعلقت به!
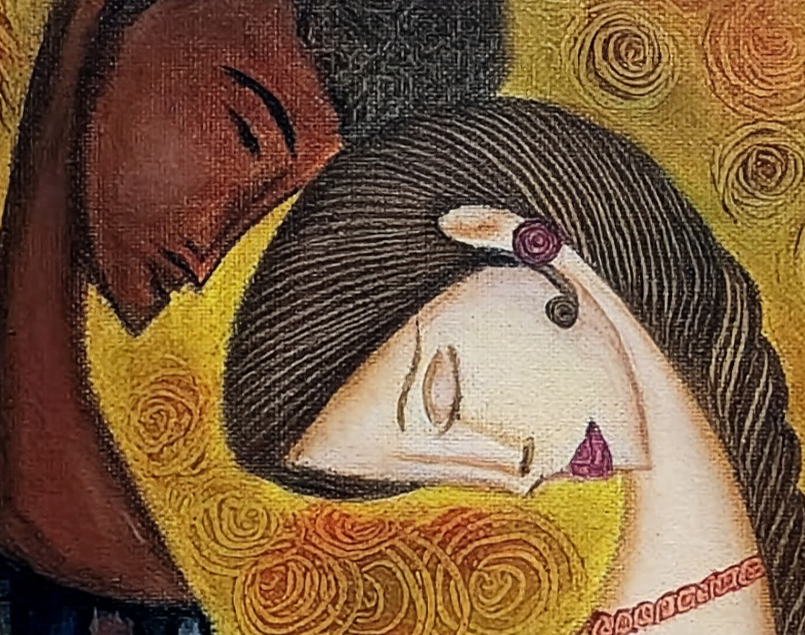



كنت عائدة من حلقة تحفيظ القرآن عندما استوقفني شاب طويل، أسمر البشرة، ذو ملامح متناسقة، وناداني: "نعمة!"
أصابتني رهبة مفاجئة. التفتُّ إلى الأعلى لأجاري طوله الفارع.
أكمل الشاب الأسمر حديثه: "نعمة! أنا جاركم، وأود سؤالكِ إذا كنتِ موافقة مبدئيًا على الزواج مني. سوف أرسل أهلي إلى بيتكم..."
قاطعته قائلة: "أمي لن توافق."
ومضيت في طريقي، لا أدري لماذا شعرت بمزيج من الحزن والاضطراب والألم في صدري.
ازدادت حالتي سوءًا. كان الوحيد الذي يلاحظ أمري هو أخي أحمد.
في يوم، أخبرت أخي بما حصل.
صمت برهة قبل أن يقول: "أمي لن توافق على خادم!"
مرت الأيام ثقيلة جدًا. أعاني من فقد ابنتي وحب لا أعرف كنهه.
في يوم، دخل أخي غرفتي وهمس لي أن جارنا الشاب الأسمر تحدث إليه بشأن زواجي منه.
قلت له: "أمي في أيامها الأخيرة، وأنت ولي الأمر."
لم أرَ أخي الأصغر هكذا من قبل؛ حيرة وتفكير وشرود دائم للذهن ممزوج بشفقة على حالي.
كانت علاقتي بأخي نادرة في مجتمعنا. كانت الفتيات في حلقات تحفيظ القرآن يستغربن عندما أخبرهن أنني أمزح مع أخي، وأنه ينظف الصحون أحيانًا ويغسل الثياب أحيانًا أخرى.
في مجتمعنا، علاقة الأخ بأخته تحيطها الريبة والشك وانعدام التعاطف.
بعد ذلك، لا أذكر بالضبط ماذا حصل، لكني تزوجت دون علم والدتي.
في ليلة توقيع العقد، دخل أخي المنزل مساءً وهو يغطي وجهه بشماغ أبي الرمادي، يخفي ورقة العقد بين ثنايا قميصه وكأنه يريد أن يخفي العار الذي لحقه دون وعي منه.
أما عن والدتي، فكنت أتوقع موتها قريبًا، وإن لم تمت، فسأمهد لها الموضوع!"
******
فاجأني مدى انفتاح نعمة لتتحدث معي بهذه الأريحية غير المعهودة وغير المريحة قليلًا بالنسبة لي. غير مريحة لأنني أشعر بثقل مسؤولية هذه الثقة، وبسبب طبيعة الكلام الذي لا يباح به إلا في مكنونات النفس.
قلت لها: "سمعت عما حصل في البحر، لكني لم أتحدث معكِ حينها لأنكِ لم تظهري قط بعدها."
قالت لي: "في اليوم الذي قررت أمي التنزه في البحر برفقة نساء الحي، كنت قد قررت مع زوجي أن أذهب معه إلى البحر أيضًا. لم أكن مستعدة لمقابلة أمي هناك، لكنها أخبرتني قبل مغادرتها أنها سوف تذهب إلى منطقة معينة وأنا كنت سأذهب إلى المنطقة المعاكسة تمامًا.
لكن خطة أمي تغيرت وذهبت إلى نفس المكان الذي كنت فيه برفقة زوجي، ورأتني هناك .
سمعت صوت صراخ مألوف بالنسبة لي: "نعمة!"
لم تكن نبرة الصوت مطمئنة.
التفتُّ، وإذا بها أمي تصيح بي: "ماذا تفعلين برفقة هذا الخادم؟ هيا تعالي إلى المنزل!"
لكن ودون وعي أمسكت يد زوجي وأنا صامتة عاجزة عن الرد.
زادت ملامح والدتي رعبًا: إذا لم تذهبي معي إلى المنزل الآن لا أنا أمك ولا أنتِ ابنتي!"
قلت لها: هذا زوجي!
الذي منع أمي من ضربي هو ضعفها ومرضها .
صاحت أمي وقد ارتجف صوتها بمزيج من الغضب والمفاجأة بعد أن أصبح مبحوحًا بفعل الصدمة والمرض الخبيث: "زوجك منذ متى؟! تعالي معي للمنزل!"
جاء صوت زوجي وكأنه من مكان بدا لي بعيدًا: "يا خالة، ابنتكِ زوجتي على سنة الله ورسوله."
وأخرج من جيبه ورقة العقد.
نظرت أمي إلى الورقة غير مصدقة وغادرت المكان على أكتاف النساء اللاتي كن معها.
كان ذلك آخر يوم رأيت فيه والدتي على قيد الحياة."
******
تعرضتُ مع زوجي وأخي للنبذ والتهميش والمضايقات والتهديد من أبناء الحي.
وقتها أذكر أنني كنت أتابع الرجال من النافذة وهم يتحدثون عن ضرورة أن يُطلقونا، وأن أبي لو كان حيًا لقتلني.
قال أحد الرجال بغضب: "ال... (وأطلق شتيمة فاحشة)، نعمة ضحكت على أخيها الأصغر، وجعلته يوقع على عقد الزواج، وتزوجت لأسرة من (الأخدام)، المعروف أنهم يتاجرون في الممنوعات!"
كانت حمية رجال الحي تثور، وكانوا يطلبون من أطفالهم أن يرموا الحجارة على منزلي ويهربوا.
ظلت أمي في رعاية نساء الحي اللواتي كن تقريبًا لا يفارقنها.
كن يقلن لها: "احسبي أن ابنتكِ ماتت، ماذا كنتِ ستفعلين؟ نحن بجواركِ لخدمتكِ."
كان أخي أحمد يغادر المنزل فجرًا قبل أن تصحو أمي، ويعود آخر الليل بعد أن تنام.
كان منبوذًا من الجميع.
ينام تحت الأشجار وعلى قارعة الطريق، ويتناول وجبتي الغداء والعشاء عندي.
تذكرت حينها أنه بعد أقل من شهرين على حادثة البحر، ماتت جارتنا أم أحمد.
عندما رأيت جثمانها للمرة الأخيرة، لم أستطع تذكر ملامحها الجميلة أبدًا.
علقت صورة وجهها النحيل جدًا والوجنتين البارزتين في عقلي لفترة طويلة.
لكن الآن، وبعد رؤيتي ابنتها التي تشبهها كثيرًا، استعدت جزءًا من ذكريات الطفولة الضبابية، ومنه ملامحها الأولى الجميلة.
قلت لها: "وسعيدة أختكِ الكبرى ما هو رأيها في كل ما حصل؟!"
قالت لي فجأة، وبدون سابق إنذار أو تمهيد: "سعيدة قتلها زوجها منذ فترة طويلة جدًا، بعد سفرها إلى إحدى دول الخليج بفترة قصيرة."
نزل الخبر عليّ كالصاعقة.
أكملت: "خبأت أمي الخبر، وتنازلت عن القصاص وأخذت الدية، والدي كان سلبيًا كعادته، والرأي والقرار كان لأمي، لم يفتحوا عزاء في ذكرى سعيدة خوفًا من كلام الناس!"
لم أستطع وقتها البكاء كما فعلت نعمة.
كانت قد مرت سبع سنوات على آخر مرة بكيت فيها قليلًا.
جاء الخبر في وقت تبلدت فيه مشاعري، ولم أعد أجيد البكاء أبدًا.
وكردة فعل عكسية من جسدي على ذلك، كان يظن الغالب أن صوتي باكٍ وعيني باكية، رغم أنني لست كذلك!
أرجو أن تغفر لي نعمة هذا الأمر الذي تكوّن من تراكمات سنواتٍ طوال لا أستطيع أن أشرحه في دقائق.
لكن عزائي الوحيد هو أن جسدي الذي لا يكذب قد يكون أظهر بعض علامات الحزن والبكاء الصامت حينها.
فكرت في نفسي: لم تقم جارتنا عزاء لابنتها خوفًا من كلام الناس، ولم تجد أحدًا من أبنائها في عزائها، لتكمل بذلك مشوار الخوف من كلام الناس حتى آخر لحظة قبل دفنها.
كان هذا آخر لقاء مع أحد أفراد هذه العائلة قبل أن ينتقلوا جميعًا إلى مكان غير معروف.