
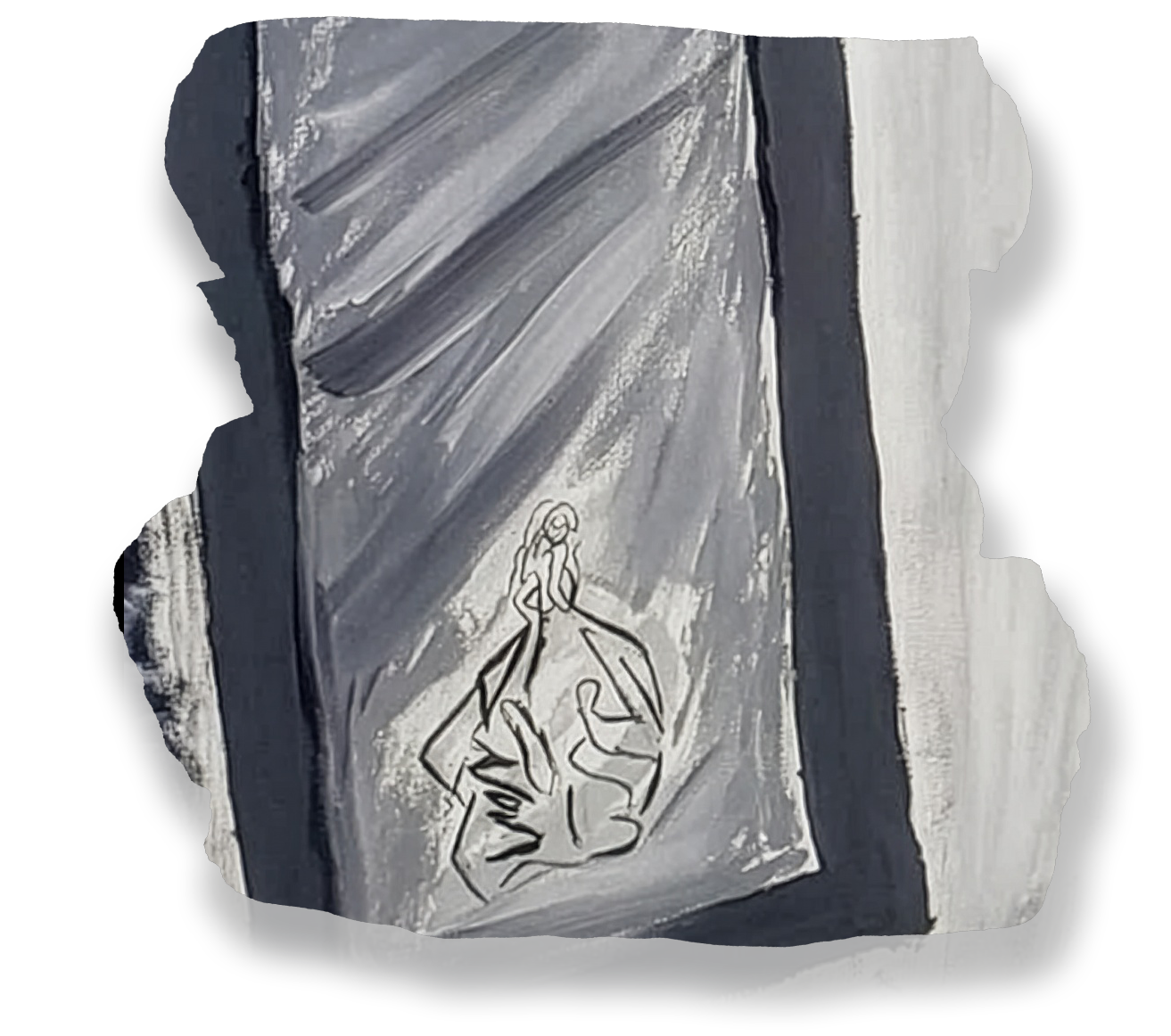

تناقضات عدة لا أكاد أحصيها، واقع مرير تصارعه الأماني سعيًا نحو تحقيقها، حقيقة واحدة لا تتغير، لا أعلم من أنا ومن سأكون!
عزيزي القارئ، في غالب الأحيان أكتب لتصفية أفكاري، ويخيل لي بأنك حين تقرأ نصي ستطرأ على بالك الكثير من الأسئلة، وقد يكون الرد عليها مفيدًا فتصبح القصة حينها منسقة البناء، كاملة الأجزاء، خاضعة لكافة أصول الكتابة، ولكني اليوم لا أسعى للالتزام بهذه الأصول، لا لأنني لا أعلم كيف أفعل ذلك، ولكن لأنني لا أريدك أن تدخل بيني وبين حديثي هذا فتلزمني حينها بوضع حدٍّ لكل أمر.
لا أفقه الكثير عن الحب والحياة، ما زلت أخوض التجارب إلى جانب ما أكتسبه من أحاديثي القليلة مع والدي والتي غالبًا ما تحدث لأمرٍ طارئ يستوجب التدخل السريع بخوض نقاش له مبرراته، حينها أنصت بحذر، أحلل بدقة، فأجد الحديث يشوبه القليل من التناقض. فكما حدث حينما أخبرني بأنه لن يكون مطمئن البال حتى أتزوج لأنني حينها سأكون تحت ظل رجل قوي غيره، ومن بعدها أخبرني بأن عليَّ أن أكون قوية في شخصيتي أدير دخلًا يسندني عند حاجتي، فهو كما يقول: لن يظل بجواري دائمًا وما إن أخطئ اختيار شريكي سيتوجب عليَّ عندها أن أتحمل نتائج أخطائي.
لم أعلم لماذا يجب عليَّ أن أكون بين أحد الخيارين، ولماذا لا أستطيع أن أكون كلاهما؟ هل أنا أنانية حينما أطالب بهما معًا؟ تساءلت إن كان والدي مخطئًا أو أنني لم أستطع فهم ما يريد إيصاله لي بحديثه هذا.
فكرت كثيرًا أنني سأتزوج بمن يختاره لي والدي كي لا أضطر لتحمل نتائج قدري السيء، عندها فقط سيكون هناك من بإمكاني أن ألقي باللوم عليه، لكن والدي -ومرةً أخرى كالمعتاد- يصدمني ويقول بأنه لن يتدخل في قراري النهائي وسيمنحني كامل الحرية عند الاختيار كي لا ألومه مستقبلًا على إجباري للزواج من شخص باختياره! مخيف هذا الأمر، ولكنه يجعلني أدرك كم أنا محظوظة لأنني ولدت في عائلة تعطيني حرية الاختيار. ذلك والدي وتلك أنا، أما من يحيطون بي من الرجال فلم أنظر لهم بجدية قط. أتتني الكثير من الخيارات، عبر البر، عبر البحر، وعبر النافذة، لكن لم يأتِ أحد منهم عبر الباب كما يقال. لم أعر أحدًا منهم اهتمامًا قط؛ فكلهم كانوا في نظري جبناء سيئي السمعة يريدون تمضية الوقت وإفراغ بعض المشاعر وترميم بعضها الآخر.. أو هكذا اعتقدت. ولذلك صددتهم جميعًا فكيف بمتسول للكلمة أن يمتلك شجاعة الفعل؟! فتعلمت كيفية أبعادهم عني ببعض الخطوات ظنًا مني أنهم حتمًا سيعودون من الباب لو كانوا يعرفون للجد سبيلا. أجدت خطواتي تلك نفعًا مع معظمهم، وأنجتني في مواقف عدة.
لم يكن والدي ذا تفكير متسلط في تعامله معي ومع أخواتي كبعض الآباء الذين تعودت سماع قصصهم؛ حيث يجبر البعض منهم فتياته على قرارات اتخذها وينصرف بعدها عن تحمل النتائج ليقع الضرر في نهاية الأمر على الفتاة ولا أحد غيرها، فتلوم ذاتها على ما لا تعلم وتتحسر على ماضيها وحاضرها، وتخاف النظر نحو مستقبلها، ومع هذا كله تخبرك في نهاية الأمر بأنها راضية عما حدث فهذا هو قدر لا مفر منه..
لا بد من أنك تتساءل الآن عزيزي القارئ: أنى لها التحدث هكذا؟ من هي وماذا تعلم؟ ها أنا أجيبك على تساؤلك في حين أخبرتك بأنني لن أفعل، وفي واقع الأمر أنت محق، لا أمتلك الخبرة، ولكني ألتقي الغرباء بين الحين والآخر، قد ألتقيهم في الحافلات العامة أو محطات انتظار، ومن ألتقيهم يمكنني تصنيفهم إلى نوعين: من يسألونني الكثير وأرتدي معهم رداء الممثلة البارعة فأختلق لهم القصص والروايات وأكون شخصية مختلفة في كل مرة، ونوعًا يخبرني الكثير، وما لا تعرفه عني هو أنني أحب الاستماع؛ فأفضل أن ألتقي بالنوع الثاني على النوع الأول.




ركبت في إحدى المرات الحافلات العامة، كتلك التي تلتقي فيها بكل فئات المجتمع، ولا أستطيع إنكار كوننا مجتمع مليء بالطبقية ويكره الاعتراف بذلك.. قابلت في ذاك اليوم امرأة كانت تجلس بجواري، لديها ابنتان أكبرهما سنًا لا تتعدى الثامنة، لا أتذكر كيف بدأ الحديث -كالعادة- ولكن كل ما أتذكره هو أنها كانت تشتكي من كل شيء، بدءًا بحياتها وأطفالها ثم زوجها، ومن بعدها تخبرني بأنها لا تستطيع فعل شيء حيال الأمر فالقضاء والقدر من يتحكمان بها. زوجها تعمد خيانتها مع امرأة أخرى فهو القدر، ثم تزوج تلك الفتاة وأحضرها لمنزلها فهو القدر مرةً أخرى، تعمل هي لتوفر كامل احتياجات منزلها! نعم إنه القدر مرة تلو الأخرى، توفر لزوجها المتربع على عرش بيتها مع زوجته الجديدة كمالياتهم ولا تستطيع فعل شيء حيال الأمر! لا بد من أنها هائمة في غرامه كي تفعل له كل هذا تحت مسمى القدر، وإن كانت كذلك لمَ تخبرني بأنها تكرهه، هل كانت تحاول استعطاف مشاعري!! ما رأيك؟
نعم قد يكون القدر أمر حقيقي لا مفر منه، ولكن هل يكون عذرًا لمشاعر خفية لا نود مواجهتها!
كنت قد انتقلت إلى مدينة أخرى للدراسة منذ فترة ليست بطويلة وليست بقصيرة. وتذكرت عندها إحدى وصايا والدي التي حرص على تلقيمي إياها بعناية قبيل مغادرته. عندما كنا نجلس أمام بحر هذه المدينة الساحر، والشيء الوحيد المغري للبقاء فيها عما سواه، حدثني والدي في يومها عما أنا مقدمة على تجربته في الحياة وعن المغريات العديدة التي سأقابلها واحدة تلو الأخرى كعتبات في طريقي، وما إن حدث ذلك فسيتوجب عليَّ عندها أن أغض الطرف جيدًا وأتماسك وإلا انهارت حياتي المتواضعة في مشتتات أنا في غنى عن اتباعها. لم أعر الأمر جدية كبيرة فكنت قد فكرت وأنا متربعة على عرشي في هذه المدينة الصغيرة: أي مغريات سألاقي يا ترى؟ هل هي تلك التي لم أر مثلها في المدينة الكبيرة التي اعتدت أن أقطن فيها؟ لا يمكن أن تكون ذاتها التي لربما لاقاها والدي في مرحلة دراسته الجامعية في أوروبا. وهل تقارن أوروبا بمثل هذه المدينة الصغيرة؟ أفكر أحيانًا: أيكون والدي على حق وأنا من أستصغر كل ما حولي من أماكن وأشخاص؟ هل سأقع بعدها ضحية إحدى المغريات التي استصغرتها؟
في الواقع، لا أعلم. أحب حياتي الهادئة البائسة وأحاول الحفاظ عليها، في غالب الأيام لا أستيقظ مع شروق كل صباح فأنا أحد أولئك الذين لا يعرفون معنى الاستيقاظ في الصباحات الباكرة بعد ليلة نوم هنيئة لأن السهر هو رفيقهم المقرب، أحد خفافيش الليل كما يناديني بعض الأصدقاء، أقضي الوقت بشكل روتيني في الذهاب الى الجامعة بعد ليلة سهر طويلة برفقة أوراقي المبعثرة في جميع أنحاء المكتبة، ثم عند العودة أغط في نوم عميق لا يوقظني بعده سوى موعد صلاة أو أداء بعض المهام الخاصة بالمسكن الذي أقطن فيه وهو أشبه منه بمؤسسة لا مسكن، وساكنيه هم موظفيه. مجرد بضع محاولات بائسة في التصرف بمثالية خرقاء تتكرر بشكل يومي، أحرص أشد حرصٍ يشوبه الكثير من الإهمال لصبارتي العزيزة فأجدها تقاوم الكثير متشبثة بالحياة. لا تزال حية حتى بعد أن تركتها دون ماء لشهر ونصف! ذلك يفسر كوني أمًا سيئة، أظن بأننا متشابهتان إلى حد ما. هي تشبهني وأنا لا أشبه أمي..